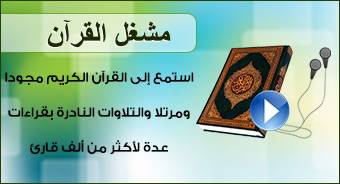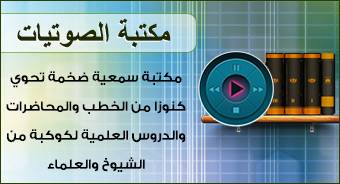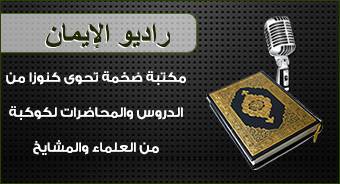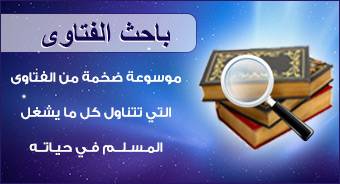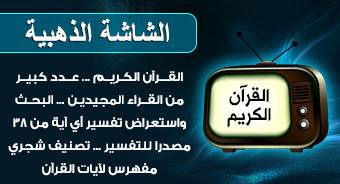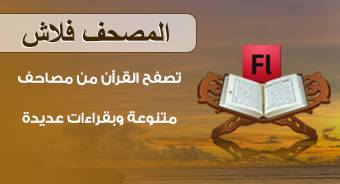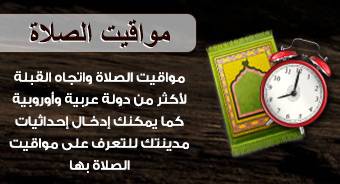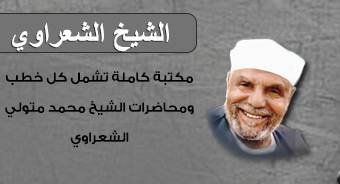|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهو لغة: كتمان العيب. والتدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشترى وإخفاؤه. والتدليس في الحديث: قسمان: الأول: تدليس إسناد: وهو أن يروى عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمعه، أو من عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه. والآخر: تدليس الشيوخ: وهو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لم يعرف به لئلا يعرف. [التعريفات ص 47، والتوقيف ص 167، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 96].
[التوقيف ص 168].
[التوقيف ص 168].
[النظم المستعذب 2/ 7].
[التوقيف ص 169].
اصطلاحا: جعل الشيء بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر. [المصباح المنير (رتب) ص 83، والتوقيف ص 169، والحدود الأنيقة ص 69].
- رعاية مخارج الحروف وحفظ الوقوف. وقيل: خفض الصوت والتحزين بالقراءة. والترتيل: رعاية الولاء بين الحروف المركبة. [التوقيف ص 170، والتعريفات ص 48].
وقيل: الأول: المشط، والثاني: التسريح. وقيل: الترجيل- بالجيم-: المشط والدهن. [المصباح المنير (رجل) ص 84، ونيل الأوطار 1/ 123، 4/ 266].
واصطلاحا: تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. وقيل: زيادة وضوح في أحد الدليلين. وقيل: التقوية لأحد المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابلين. [المصباح المنير (رجح) ص 83، والكليات ص 315، والتوقيف ص 170].
وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والحانق، وهما ترقوتان من الجانبين، والجمع: التراقي. - قال بعضهم: ولا تكون الترقوة لشيء من الحيوانات إلّا للإنسان خاصة. [المصباح المنير (ترقوة) ص 74، ونيل الأوطار 5/ 269].
[القاموس القويم ص 300، ونيل الأوطار 2/ 196].
بمعنى جعل له سعرا معلوما ينتهى إليه. واصطلاحا: عرّفه القاضي عياض: بأنه إيقاف الأسواق على ثمن معلوم لا يزاد عليه. وعرّفه ابن عرفة: بأنه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. [المصباح المنير (سعر) ص 105، ومشارق الأنوار 2/ 225، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 356].
[المصباح المنير (سلم) ص 109 (واضعه)].
واستعمل المالكية أيضا: (التقارر) بمعنى: التصادق. [الموسوعة الفقهية 12/ 51].
- وعند المحدثين: هو الحكم على الحديث بالصحة إذا استوفى شرائط الصحة التي وضعها المحدثون. - والتصحيح عند أهل الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرءوس، أو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. - وعند الفقهاء: هو رفع أو حذف ما يفسد العبادة أو العقد. [الروض المربع ص 363، والموسوعة الفقهية 12/ 55].
وفي الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام. [القاموس المحيط (صرف) 1069، والموسوعة الفقهية 6/ 145، 12/ 71، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 98].
قال أبو عبيد: (المصراة): الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال منه: (صريت الماء)، ويقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت. قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة. قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، وقول الشافعي: صحيح، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن النجش والتصرية». [مسلم (البيوع) ص 12] أقول: وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه. [النهاية في غريب الحديث 3/ 27، والمصباح المنير (صري) ص 129، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 176، والتوقيف ص 179].
ومنه سمّى عقد البيع صفقة، إذ جرت العادة في العقود أن يضرب البائع يده على يد المشتري أو العكس، ومن هنا قالوا: صفقة رابحة، وصفقة خاسرة، والتصفيق باليد: التصويت بها. وفي الحديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء». [البخاري (السهو) 9] وذلك إذا ناب المصلى شيء في صلاته فأراد تنبيه من بجواره. [المصباح المنير (صفق) ص 130، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 178، والكليات ص 563، والموسوعة الفقهية 12/ 78].
وعرف المناوي: (التصميم): بأنه المضي في الأمر غير مصغ إلى من يعذله، كأنه أصم. [المصباح المنير (صمم) ص 132، والتوقيف ص 179].
قال الفيومي والمناوي: تمييز الأشياء بعضها عن بعض. قال المناوي: ومنه تصنيف الكتب. وصنف الأمر تصنيفا: أدرك بعضه دون بعض، ولوّن بعضه دون بعض. قال ابن فارس عن الخليل: (الصنف): الطائفة من كل شيء. وقال الجوهري: (الصنف): النوع والضرب، وهو بكسر الصاد وفتحها: لغة حكاها ابن السكيت وجماعة. وجمع المكسور: أصناف، مثل: حمل، وأحمال. وجمع المفتوح: صنوف، مثل: فلس، وفلوس. [معجم المقاييس (صنف) 578، والمصباح المنير (صنف) ص 133، والتوقيف ص 180].
والصورة: التمثال، وجمعها: صور، مثل: غرفة، وغرف. فتصورت الشيء: مثلت صورته وشكله في الذهن فتصوّر هو. وفي (التوقيف): حصول صورة الشيء في العقل. والتصور عند علماء المنطق قسم من أقسام العلم يقابل التصديق، أو هو أخص من التصديق، فعلى الثاني قال القطب الرازي: العلم إما تصور فقط، وهو: حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم، وهو: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ويقال للمجموع: (تصديق). وعلى ذلك، فالعلم إما تصور فقط: أي تصور لا حكم معه، ويقال له: (التصور الساذج) كتصور الإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات على وجه الجزم أو الظن. وإما تصور معه حكم، ويقال للمجموع: (تصديق)، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب. وعرّفه الشيخ الشنقيطى: بأنه إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه، كإدراك معنى اللذة، والألم، ومعنى المرارة، ومعنى الحلاوة. فائدتان: - علم التصور: قد يكون ضروريّا، وقد يكون نظريّا. والضروري: وهو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل، أو ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتصور الحرارة، والبرودة. والنظري: ما يحتاج إدراكه إلى التأمل، أو ما يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتصور العقل، والنفس. - الطريق الذي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها فيدخل فيه: الحد، والرسم، واللفظي، والقسمة، والمثال، وتسمى بالقول الشارح، وتفصيلها في كتب (المنطق). [المصباح المنير (صور) ص 134، والكليات ص 290، وتحرير القواعد المنطقية ص 7، وآداب البحث والمناظرة للأمين الشنقيطي ص 8، 9، 11، 33، والمنطق الصوري للدكتور/ يوسف محمود ص 11، 12، والتوقيف ص 108، وضوابط المعرفة لحبنكه ص 18، 19، والتعريفات ص 61]. |